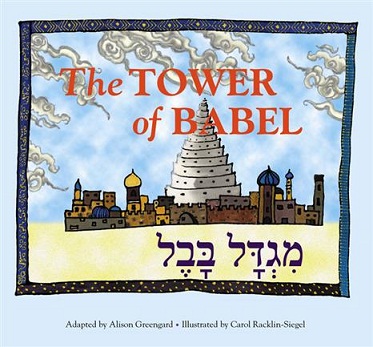بابل الجديدة، من إبداعات الصّهيونيّة في فلسطين، لم توحّد أشتاتها اللّغة العبريّة، كما اعتقد قادتها وأرادوا. بل وحّدها ويوحّدها الخوف، على الأغلب. الخوف من ساكن الأرض الأصلي، أو من المستقبل، أو من فراغ الأسطورة.
في بداية القرن العشرين، ولمنع بابل جديدة في فلسطين، خلقت الحركة الصّهيونيّة هيمنة لغويّة على أتباعها. على الرغم من اشمئزاز قادتها من ثقافات الشتات ودياناته، اضطرّت الحركة لتبنّي لغة التّوراة، لغة الدّين، فتجمع بين الخلفيّات والثّقافات المتعدّدة. وقد نجحت في جعل العبريّة لغة المستوطنين الجدد، عن طريق غسيلٍ لغويّ قاسٍ، سهّل من عمليّة الاندماج الاستعماري، لكنّ نتائجه ما زالت قيد الانجلاء، رُبَّ مُبَلبلة.
"القادمون الجدد" لا يتكلّمون العبريّة
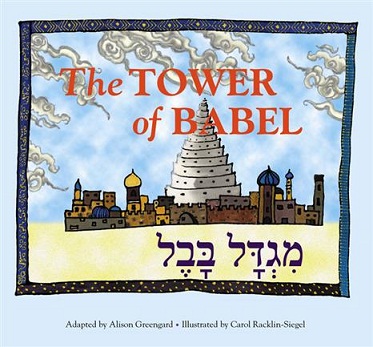 في الموجة الرّابعة (1924-1928) والخامسة (1929-1939) من الهجرة اليهوديّة إلى فلسطين، واجه قادة الحركة الصّهيونيّة إشكالًا في دمج "القادمين الجدد" داخل المستوطنات الزّراعيّة. غالبيّتهم كانوا أوروبّيين من أصحاب رؤوس الأموال والطّبقة الوسطى الذين افتقروا إلى المعرفة بالزّراعة، كما الرّباط مع الثّقافة اليهوديّة واللّغة العبريّة.
في الموجة الرّابعة (1924-1928) والخامسة (1929-1939) من الهجرة اليهوديّة إلى فلسطين، واجه قادة الحركة الصّهيونيّة إشكالًا في دمج "القادمين الجدد" داخل المستوطنات الزّراعيّة. غالبيّتهم كانوا أوروبّيين من أصحاب رؤوس الأموال والطّبقة الوسطى الذين افتقروا إلى المعرفة بالزّراعة، كما الرّباط مع الثّقافة اليهوديّة واللّغة العبريّة.
فحتّى بعد استيطانهم في فلسطين، ظلّت اللّغات والثّقافة الأوروبّيّة تربطهم مع الخارج. (عام 1943 كان هنالك قرابة 300,000 شخص من سكّان المجتمع اليهودي في فلسطين ممّن لا يتكلّمون اللّغة العبريّة بطلاقة).
كانت القدس، مثلًا، تحوي عددًا كبيرًا من اللّغات داخل المجتمع اليهودي، من بينها الإسبانيّة والعربيّة (بلهجاتها الفلسطينيّة والمغربيّة وغيرها) والشّرق أوروبّية، كالييديش، التي تمزج ما بين العبريّة والألمانيّة. فآثر سكّانها التّكلّم بلهجاتهم ولغاتهم الأمّ على العبريّة، والّتي كانت تعتبر لغة الدّين لا غير - لغة قديمة ولا محلّ لها من التّعامل اليومي. أيّ، تمسّكوا بجذورهم الأوروبّيّة والعربيّة، وبالتّالي لم يتماثلوا مع فكرة المستوطن اليهودي المثالي المرسومة في خيال قادة الحركة الصّهيونيّة.
عدا ذلك، هدّد جهل المستوطنين الجدد بالزّراعة والحياة في المستوطنات الزراعيّة، الحلم الصهيوني واستعماره بالفشل. فمن دون العلاقة مع الأرض أو اللّغة، خاف قادة الحركة من مقاومة المهاجرين للرّوح الجماعيّة القوميّة العبريّة، ومن إعاقتهم لخلق مجتمعٍ متجانس من العمّال المنتجين الطلائعيّين ليفلحوا الأرض ويستوطنوها.
وكان من ناقدي التوجّه الأخير حاييم وايزمن، رئيس "المنظّمة الصّهيونيّة العالميّة" آنذاك، إذ حذّر من الفراغ الثّقافي والرّوحاني للحركة، ونصح بالتّركيز على الثّقافة العبريّة لتفادي فشل المشروع: "إنّنا ملزمون بالمهمّة الملحّة بتدعيم البنية الرّوحانيّة [في فلسطين]؛ علينا بمضاعفة نشاطنا في مجال الثّقافة العبريّة في كلا المستوطنات الزّراعيّة والشّتات. ستكون تلك خطيئة لا تغتفر إن اكتفينا بإنشاء مشاريع اقتصاديّة بحت وأهملنا المحتوى الثّقافي للصّهيونيّة". أمّا أحاد هعام، أحد شعراء الحركة، فشارك وايزمن قلقه متّهمًا الحركة بفراغٍ روحانيّ وثقافيّ لم يرَ مثيله من قبل، وانتقد الحركة بتركيزها على مادّيّة المشروع الصّهيوني (أي البنيان والاستعمار وتكثيف أعداد المهاجرين) وإهمالها للوجه الثّقافي.
بقي التخوّف الأكبر لدى أصحاب الحلم الصهيونيّ من بابل جديدة، وفيضانٍ لغويّ وعرقيّ جديد. كانوا يخشون انقسام المستوطنات إلى أجزاء صغيرة من اللّغات والعادات والخلفيّات، وكانوا بحاجة لتفادي نتائج عبثيّة الخليط. ولخّص بن-تسيون دينور، أحد مستوطني الموجة الرّابعة، قراءته للأجواء العامّة كالتّالي: "كلٌّ يصلّي بحرارة على طريقته، كلٌّ يعترف بذنوب غيره على الملأ بأسلوبه… ما ينقصنا هنا هو فكرة الرّأي العام… فلدينا طبقات ومجتمعات عرقيّة مختلفة وأساليب عيش متعدّدة، خاصّةً في المدن. الأشكنازي لا يعير رأي اليمنيّ اهتمامًا، ولا المهاجر رأي العربيّ، واثناهما لا يلتفتان لرأي اليهوديّ-البولنديّ. «الحلوتسيم» يحتقرون ساكني المستوطنات القديمة، بينما يتساءل هؤلاء عمّا إذا كان يحقّ لغيرهم التّواجد في إسرائيل بكلّيّتها. من الواضح أنّه لا يوجد رأيٌ عام واحد وموحّد لحياة قوميّة، لا رقابة اجتماعيّة على تصرّفات الأفراد. الأمر برمّته يذكّرني بصفٍّ علاجي تركه مدرّسه على أهوائه ولم يعد".
جميعاً.. وبهدوء، كما الأسد
أتى العلاج عن طريق الهيمنة. الهيمنة اللّغويّة والثّقافيّة وفرض العبريّة على جميع المستوطنين (الأيديولوجيّون منهم والاقتصاديّون). فأقرّ قادة الحركة الارتكاز على نشر اللّغة العبريّة والتّشديد على استخدامها في جميع جوانب الحياة. وكان أحد أساليب رئيس المنظّمة الصّهيونيّة العالميّة (والوكالة اليهوديّة في ما بعد) دافيد بن-غوريون هو إصدار الكتب العبريّة وتوزيعها بشكلٍ مكثّف، وعلى مستوى قوميّ وشامل.
 فشدّد على نشر الكتب العبريّة السياسيّة والقوميّة على أوسع نطاقٍ جماهيريّ ممكن، وأراد توزيع كتب تتطرّق إلى اللّغة العبريّة والأدب العبري و«أرض إسرائيل» باللّغة العبريّة فقط. أمّا زملاؤه فاقترحوا توفير دروسٍ ودورات ومحاضرات باللغة العبريّة، وشدّدوا على استخدام الراديو ووسائل الاتّصال الأخرى باللّغة العبريّة فقط، مانعين صدور المجلات والإعلانات المكتوبة بغير العبريّة. كما اقترحوا إقامة المهرجانات الأدبيّة وإنشاء جامعة متنقّلة ومراكز ثقافيّة عبريّة واستخدام مراكز شعبيّة لإقامة برامج ثقافيّة، كلّها بهدف ترسيخ اللّغة في ذهن المستوطن الجديد.
فشدّد على نشر الكتب العبريّة السياسيّة والقوميّة على أوسع نطاقٍ جماهيريّ ممكن، وأراد توزيع كتب تتطرّق إلى اللّغة العبريّة والأدب العبري و«أرض إسرائيل» باللّغة العبريّة فقط. أمّا زملاؤه فاقترحوا توفير دروسٍ ودورات ومحاضرات باللغة العبريّة، وشدّدوا على استخدام الراديو ووسائل الاتّصال الأخرى باللّغة العبريّة فقط، مانعين صدور المجلات والإعلانات المكتوبة بغير العبريّة. كما اقترحوا إقامة المهرجانات الأدبيّة وإنشاء جامعة متنقّلة ومراكز ثقافيّة عبريّة واستخدام مراكز شعبيّة لإقامة برامج ثقافيّة، كلّها بهدف ترسيخ اللّغة في ذهن المستوطن الجديد.
وبهدف التصعيد اللّغوي، اتّفق ميناحيم أوسيشكين ومئير بار-إيلان وناحوم لفين ويتسحاك بن-تسفي وغيرهم من قادة الحركة الصّهيونيّة، في اجتماعٍ لهم عام 1941، على شنّ الحرب على التّعدّديّة. أي، قمع التّعدّديّة الأيديولوجيّة واللّغويّة في المجتمع اليهودي في فلسطين و"شتل" اللّغة والثّقافة العبريّة مكانهما.
اتّفقوا على فرض الانضباط القومي بهدف توحيد وتأمين التحام "الشّعب" لتحقيق الحلم الصّهيوني. كما اتّفقوا على تطبيق ذلك كلّه بهدوء. فضّلوا عدم اللّجوء إلى فرض اللّغة على مستوى حكوميّ-مؤسّساتيّ، وإنّما بشكلٍ "لطيف"، مفضّلين التّأثير على وتطويع إرادة الأفراد الدّاخليّة بدل السّيطرة عليها من الخارج. أي، فضّلوا زرع الفكرة والأسطورة في الدّاخل من دون ضجّة زائدة. وشبّه أحدهم، دافيد ريميز، هذا الأسلوب بأسلوب الأسد، ناصحًا القادة بالتّروي والهدوء: "من المحبّذ لنا أن نخبئ براثننا عند فرضنا للّغة العبريّة على الشّعب. كما الأسد، علينا ألا نستعرض براثننا [عند الهجوم]. علينا التّشبّه بالأسود لا الدّيوك".
وكذا كان. ارتكز القادة على تغيير العقول، والشّعب، من الدّاخل أوّلًا. ومن أكثر لينًا من الأطفال لتقبّل لغة وفكرة جديدة؟ فكانت الفكرة قبل اللّغة - علّموهم أنّ العبريّة لغة ذات مقام أسمى من غيرها، وأنّها أفضل بكثير من لغة "الشّتات" وعاداته. أرادوا للطّفل أن يتحدّث العبريّة وأن يفخر بها. أن يتكلّمها وينشرها لغيره من الأصدقاء والعائلة. أرادوه أن يتكلّمها بغضّ النّظر عن صعوبة التّواصل بها مع والديه وعائلته. أرادوه مستوطنًا مثاليًّا، يفخر بكونه جزءًا من الأسطورة العبريّة، بلغتها وثقافتها وحلّتها الجديدة. أرادوه أن ينسى ماضي عائلته الثّقافي واللّغوي (عدا ماضي الخوف، طبعًا) وأن يتمّم بناء الأسطورة، حرفًا بعد آخر.
ومن ثمّ أرادوا له أن يعلّمها، تلقائيًّا، لأولاده عند ولادتهم وزرعها وأهميتها في نفوسهم. فكان أن اقترح ناحوم لفين، أحد قادة الحركة، مثلًا، أن يفصل ما بين المولود وأمّه التي لا تتكلّم العبريّة كي لا تؤثّر هي على تطوّر لغته العبريّة. اقتراحٌ آخر كان أنّ توفّر الوظائف فقط للتّلاميذ والطّلاب الّذين درسوا العبريّة. ويبدو أنّ هذه الوسائل وغيرها نجحت في زرع نزعة لغويّة للعبريّة، بحيث أصبح من الطّبيعي أن ينبذ كلّ من لا يتكلّم العبريّة في المستوطنات في فلسطين، وأن يُغضب على كلّ فيلم أو شارة غير معروضين باللّغة العبريّة. بالأخير، كان منهم من رأى أنّ بذل هذا الجهد الثّقافي - الاجتماعي يساوي بأهميّته نشاط فرض الأمن والاستيطان. رأوا أنّ ما سيستثمرونه لغويًّا وثقافيًّا في بداية المشروع الصّهيوني، سييعود عليهم بفائدة توحيد الحلم في المستقبل..
إلى أين، لغويًّا؟
 اليوم - مستقبل الماضي، وعلى الرّغم من نجاح المشروع الحالي بكلّ ما في الآنيّة من معنى، لا يزال التّساؤل الأوّلي لقادة الحركة الصّهيونيّة يطرح نفسه. الخوف من الفراغ لا يزال يساور الحركة، ولو بهدوء. القلق من مستقبل الحركة، ولو أنّه مدفونٌ تحت طبقات من "النّجاح اللّغوي" ما زال يراود كلا القادة والشّعب، بالرّغم من افتقارهم لحنكة أجدادهم. قد يكون مشروع إعادة إحياء اللّغة العبريّة قد نجح، لكنّ "الفراغ الرّوحاني والثّقافي" لا يزال ينتظر علاجه.
اليوم - مستقبل الماضي، وعلى الرّغم من نجاح المشروع الحالي بكلّ ما في الآنيّة من معنى، لا يزال التّساؤل الأوّلي لقادة الحركة الصّهيونيّة يطرح نفسه. الخوف من الفراغ لا يزال يساور الحركة، ولو بهدوء. القلق من مستقبل الحركة، ولو أنّه مدفونٌ تحت طبقات من "النّجاح اللّغوي" ما زال يراود كلا القادة والشّعب، بالرّغم من افتقارهم لحنكة أجدادهم. قد يكون مشروع إعادة إحياء اللّغة العبريّة قد نجح، لكنّ "الفراغ الرّوحاني والثّقافي" لا يزال ينتظر علاجه.
لغويًّا، نُقلت العبريّة من الكتاب إلى الشّارع، من المكتوب إلى المحكيّ. تاريخيًّا، أصبحت حياة سكّان أرض فلسطين، المستوطنون منهم والأصليّون، منوطة بلغة غريبة عنهم. فلا يتخرّج أيّ فلسطيني داخل الخطّ (الخيالي) الأخضر من مدارس المنهاج الإسرائيلي إلا بعد إنهائه تعلّم اللّغة العبريّة، بمستويات متفاوتة. ولا يذهب سائقٌ في مشوارٍ لتّأمّل الطّبيعة في الشّمال من دون أن يقرأ أسماء القرى والمدن بالعبريّة (أو العربيّة الرّكيكة، والمعبرنة). أمّا توظيفه، فمن دون إتقانه للّغة صعب، وشبه المستحيل هو التحاقه بالجامعة من دون دراسته للّغة العبريّة. لكن، درويشيًّا إن صحّ التّعبير، تتبدّد اللّغة كالسّحابة، وتخون حاملها في بعض الأحيان. فاللّغة سرابٌ على قدر ما هي حقيقيّة. واللّغة لا تعالج فراغًا لم تخلقه هي. اللّغة لا تحلّ محلّ الأرض، مع كلّ ما فيها من جماليّات. اللّغة لا تلغي التّعدّديّة الثّقافيّة ولا تقمع الخلفيّات المختلفة. على العكس، اللّغة تحتضنها جميعًا داخل تقاطيع أحرفها.
مأسسة القمع اللّغوي، السرّي والعلني، لا يربط بين مستوطنين تكلّموا وما زالوا يتكلّمون بأيديولوجيّات مختلفة، كلٌّ على طريقته، وكلٌّ على إنكليزيّته، وفرنسيّته. فرض اللّغة على خلفيّات مختلفة لا يملأ فراغ صندوق الثّقافة الذي أقفر، مسرّبًا أمواله لتمويل حربٍ بعد أخرى. انتشار اللّغة العبريّة في فلسطين لم يعالج كبرياء اليهودي الأوروبّي على اليهودي الشّرقي، ولم ولن يجعله أقلّ عنصريّة. أمّا فيضان اللّغات والثّقافات والخلفيّات الذي أقلق قادة الحركة، فلم يوقفه إحياء اللّغة العبريّة.
بابل الجديدة، من إبداعات الصّهيونيّة في فلسطين، لم توحّد أشتاتها اللّغة العبريّة، كما اعتقد قادتها وأرادوا. بل وحّدها ويوحّدها الخوف، على الأغلب. الخوف من ساكن الأرض الأصلي، أو من المستقبل، أو من فراغ الأسطورة.