تتفاقم ظاهرة الإسلاموفوبيا Islamophobia أو رهاب الإسلام في المجتمعات الغربية، في سياق تنامي الحركات الاسلاميّة في العالمين العربي والاسلامي.
حسين سمّور
 تتفاقم ظاهرة الإسلاموفوبيا Islamophobia أو رهاب الإسلام في المجتمعات الغربية، في سياق تنامي الحركات الاسلاميّة في العالمين العربي والاسلامي.
تتفاقم ظاهرة الإسلاموفوبيا Islamophobia أو رهاب الإسلام في المجتمعات الغربية، في سياق تنامي الحركات الاسلاميّة في العالمين العربي والاسلامي.
وظهر مصطلح الاسلاموفوبيا في سبعينيّات القرن الماضي، ولكن ظلّ استعماله ضعيفاً حتى بدايات هذا القرن، وخاصة بعد أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر من العام 2001، حيث بدأت موجات الخوف تجتاح المجتمعات الغربية.
حاول الغرب وبالاخص "النخب وأصحاب القرار" حينها، إظهار الازمة مع العرب أو مع المسلمين في الشرق خاصة، على أنها أزمة الاختلاف في نظام القيم، لأن المجتمعات الغربيّة تقدم نفسها على أنها تقوم على الديمقراطية وتقديس "الحريات الشخصية للافراد".
محاولات شيطنة الاسلام بدأت مع نهاية الحرب العالمية الثانية
بعد نهاية الحرب العالميّة الثانية خرجت العديد من الدراسات، أهمها بعد مجيء "جون فوستر دالاس" كوزير خارجيّة للولايات المتحدة الامريكية بين "1953 – 1959"، وطُرحت وقتها نظريّة "ماذا يجب أن نضخ في العالم؟ وكان الرأي أنه يجب أن نضخ في الشرق الاوسط أعلى نسبة من الله".
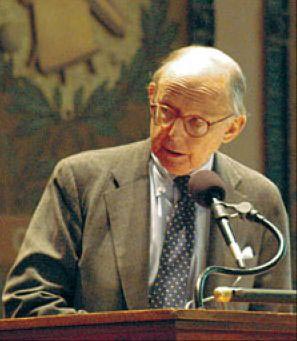 ويعتبر صاموئيل هينتنغتون مستشار البنتاغون والذي نظّرَ لصدام الحضارات، أنه "بالنسبة للشعوب الباحثة عن هوية والتي تريد اختراع العرقية فإن العدو ضروري"، وكان لا بد للولايات المتحدة الامريكية أن تجد عدواً لتستمر، فوقع الخيار على الاسلام.
ويعتبر صاموئيل هينتنغتون مستشار البنتاغون والذي نظّرَ لصدام الحضارات، أنه "بالنسبة للشعوب الباحثة عن هوية والتي تريد اختراع العرقية فإن العدو ضروري"، وكان لا بد للولايات المتحدة الامريكية أن تجد عدواً لتستمر، فوقع الخيار على الاسلام.
الولايات المتحدة وبحسب مراقبين لسياسة واشنطن، رفعت شعار الإرهاب الذي ربطته بالاسلام، والحرب على الارهاب منذ ذلك الوقت، في محاولة منها لشدّ عصب المجتمع الامريكي ومن ورائه المجتمعات الاوروبيّة.
وبعد نهاية الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفياتي، وما كان يعرف بالثنائية القطبية، بات واضحاً أن النظام العالمي الجديد "حينها" الذي تقوده الولايات المتحدة الامريكية، هو عالم محكوم عليه بالتنافر والتصادم الحضاري.
وكانت الحركات الاسلامية في تلك المرحلة وخاصة في أفغانستان وجزء من آسيا الشرقية، قد خرجت من قمقم من صنعها، فأعيدت وقتها عملية الشيطنة "أي شيطنة الاسلام".
المصادر هنا تؤكد أن هذه الحركات مثل تنظيم القاعدة وحركة طالبان، هي منذ البداية من صناعة الولايات المتحدة الامريكيّة وبريطانيا وبعض الدول الأوروبية الاخرى، كانت تستخدمها كورقة تواجه بها طموحات الاتحاد السوفياتي حينها في شرق آسيا وخاصة في "أفغانستان وباكستان".
وتستند المصادر بذلك على كلام وزيرة الخارجية الامريكية السابقة هيلاري كلينتون التي اعترفت في أكثر من مناسبة، أن واشنطن ساهمت بانشاء هذه الحركات وقامت بدعمها ماديا وعسكريا في مختلف المواقع، بهدف تحقيق أهدافها في الشرق الاوسط وشرق آسيا، بوجه النفوذ الروسي والايراني المتقدم في المنطقة.
هذه السياسة الغربية أعادت تحويل الاسلام المعاصر الى نوع من عدو، يخيف المجتمعات الغربية وحاولت أن تقدم هذه الحركات الاسلامية على أنها تقاتل الغرب، ونتج عن ذلك تضييق على المجتمعات الاسلامية في الغرب ثقافيا وسياسيا، فبرزت سهولة الاعتقال والتوقيف ورصد الحياة الشخصية للمسلمين في تلك الدول. وساهم تصوير الاسلام على هذا النحو بخروج موجة الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للاسلام في أوروبا وممارسات تحت عنوان حرية التعبير كالذي قام به القس الامريكي تيري جونز عبر حرق نسخ من القرآن الكريم، مع العلم أن الموضوع لا يمت الى الحرية بصلة.
ونجد أنَّ عملية تظهير الاسلاموفوبيا في الثقافة والسياسة والفكر هي عملية مبرمجة، فالتمظهر الثقافي الكبير الذي ظهر بعد 11 ايلول، وقتها أخذ الاسلام الى مكانين "تمظهر ثقافي وتمظهر سياسي".
_ أما التمظهر الثقافي فهو محاولات وسائل الاعلام "ومعظمها مملوك من الصهيونية العالمية"، التركيز على الخلفية الاسلامية المتعصبة، أي اظهار الثقافة الاسلامية وكأنها ليس لها علاقة بالمعاصرة أو بإنجازات العلم.
_ التمظهر السياسي هو التركيز على اظهار الاسلام وكأنه هو الذي يهجم على الغرب.
وفي تلك المرحلة بالذات خرج الرئيس الامريكي جورج بوش الابن ليصوب على الاسلام، وطرح سؤاله الشهير حينها "لماذا يكرهوننا؟"، ليبرر من ورائه تدخّل الولايات المتحدة الامريكية في شؤون المجتمعات الاسلامية، ودعمها لاسرائيل، واعتماد ازدواجية المعايير وسياسة الحروب المتنقلة في الشرق الاوسط وشرق آسيا، والهيمنة على المؤسسات الدولية.
وتؤكد مصادر متابعة لهذا الشأن أن "شيطنة الاسلام بالثقافة الغربية وخاصة عند النخب، تقتضي أن يقال ان الاسلام هو بربري وبدائي، وكل من له علاقة بالاسلام خاضع لمفهوم الارهاب، فعَمِل الفكرُ الحاكم في الغرب على زج جميع موبقات العالم في الاسلام، وذلك بغض النظر عن القراءة المتأنية للفكر الاسلامي أو المعطى الاسلامي أو الثقافة الاسلامية أو الحضارة الاسلامية".
الكثير من الحركات التي ترفع شعار الاسلام اليوم .. في حقيقتها تسيء للاسلام ومدعومة غربيا
 الحركات التي تقدم نفسها اليوم على انها حركات اسلامية، وتقوم بما تسميه الجهاد من سوريا الى مصر وتونس والجزائر وصولا الى أفريقيا، هي في حقيقتها ليست حركات ناضجة.
الحركات التي تقدم نفسها اليوم على انها حركات اسلامية، وتقوم بما تسميه الجهاد من سوريا الى مصر وتونس والجزائر وصولا الى أفريقيا، هي في حقيقتها ليست حركات ناضجة.
فيجب التمييز بين الاسلام المقاوم الذي يضم الحركات التي تواجه الاحتلال، وقاتلت الاستعمار على مدى عشرات السنين، وبين الاسلام التغييري الاصلاحي، وبين "الاسلام" التكفيري الاصولي الذي خلق المشكلة عبر اطلاق شعارات طائفية، والدخول في صراعات مع الاخرين. وقام هذا الفريق بتكفير جميع الناس المختلفين عنه حتى داخل المسلمين.
هذا النوع هو الذي يقاتل اليوم في سوريا تحت لواء تنظيم القاعدة، أو الحركات التي تنضوي تحت لواء ما يسمى الدولة الاسلامية في سوريا والعراق، وتقوم بارتكاب المجازر وقتل النساء والاطفال على شاشات التلفزة دون أي رادع ديني او اخلاقي.
ومثل هذه الممارسات لا تمت الى الاسلام بصلة، بل هي ممارسات ارهابية نتيجة تعبئة من بعض الجهات، وتجري تحت أعين دول اقليمية ودوليّة تواصل دعمها لهذه الجماعات رغم علمها واقتناعها بارتكابها لهذه الممارسات والمجازر.
 الغرب يواصل دعمه لهذه الجماعات حماية لـ"إسرائيل" التي تحافظ على مصالحه في المنطقة
الغرب يواصل دعمه لهذه الجماعات حماية لـ"إسرائيل" التي تحافظ على مصالحه في المنطقة
على المستوى الاستراتيجي ، فان واشنطن تعلم جيدا أنَّ مثل هذه الممارسات تخدم مشروعها الكبير وهو إغراق المنطقة في الفوضى بهدف تقسيمها الى دويلات مذهبية، وهذا كله في النهاية يصب في مصلحة الكيان الصهيوني الذي يقف متفرجا اليوم على الفوضى الحاصلة في المنطقة.
ويظهر ذلك بشكل واضح على لسان المسؤولين الغربيين وخاصة الامريكيين والفرنسيين والبريطانيين، الذين يجاهرون بدعمهم لهذه الجماعات في سوريا عسكريا وماديا، فيما يطلقون شعارات محاربة الارهاب في أماكن اخرى من العالم، وهذا يثبت فكرة ازدواجية المعايير التي تحثنا عنها في البداية.
فهدف الغرب من كل ذلك الحفاظ على مصالحه في المنطقة وحماية أمن "اسرائيل"، وابقاء المنطقة في حالة صراع في محاولة منه لاستنزاف القوى التي تحارب اسرائيل وتقف بوجه المشروع الغربي في المنطقة، والذي يهدف الى تقسيمها لدويلات صغيرة بدأت معالمها تتكشف منذ "سايكس بيكو" مرورا بالغزو الامريكي لافغانستان والعراق وليس انتهاء بدعمه للحركات التي تطالب باقامة امارات وحكم ذاتي في سوريا وغيرها من المناطق في الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
وهذا المشروع لم ينكره الغرب يوما، فغالبية الدوائر الغربية تؤكد على أهمية دور "اسرائيل" كحافظ لمصالح الغرب، باعتبارها قاعدة متقدمة في المنطقة، وان كل ما يحصل يصب في مصلحة هذا الكيان، ويهدف الى حماية وجوده. وهذا ما قاله رئيس الوزراء الاسباني الاسبق خوسيه ماريا آثنار - الذي انشأ في العام 2010 "مبادرة اصدقاء إسرائيل" - والتي تهدف الى " مناهضة محاولات نزع الشرعية عن دولة اسرائيل وحقها في العيش بسلام وحقها في الدفاع عن نفسها"، معتبرا ان سقوط اسرائيل يعني سقوط الغرب بأسره. ومن هنا تبرز أطماع الغرب واهدفاه على حد سواء، وهو ضمان أمن اسرائيل، ووضع يده على المنطقة للتحكم بثرواتها النفطية والمائية.
مواجهة المشاريع الغربية تبدأ بمد جسور التواصل واعتماد خطاب أكثر عقلانية
تتحمل المجتمعات في منطقة شرق آسيا والشرق الاوسط ، على اختلافها مسؤولية مواجهة المشاريع الامريكية في المنطقة، وقطع الطريق على طموحات واشنطن الساعية لتفتيت هذه المنطقة.
فإعادة مد جسور التواصل بين المسلمين والمسيحيين، وحتى بين المسلمين أنفسهم والمسيحيين أنفسهم، تقرب وجهات النظر بين الجميع، وتعيد بلورة فكرة التعايش بين أبناء هذا الشرق على اختلافهم، كما كانوا منذ آلاف السنين.
وان التركيزعلى فكرة التعايش والحوار، تضرب نظرية صراع الحضارات التي ولدت من الولايات المتحدة الامريكية، بهدف التأثير على الشعوب وخلق صراعات بين المجتمعات المختلفة في المنطقة.
فالتعرف على الاسلام الحقيقي هو مسؤولية جميع أبناء هذه المنطقة وبالاخص المسلمين انفسهم، عبر المواجة وبمختلف الوسائل الفكرية والسياسية، للحركات التي تنسب نفسها للاسلام وتمارس القتل باسمه.
فمثل هذه الاجراءات اذا ما تم اعتمادها ، ستغير مع الوقت الصورة التي زرعها الغرب في عقل مجتمعاته ، وهي صورة الاسلام الذي يهجم ويقتل.
يجب الاضاءة على الانجازات التي ولدت من رحم المجتمعات الاسلامية والشرقية عموما، كما هو الحال في الجمهورية الاسلامية الايرانية ، وما وصلت اليه من تطور علمي وتقني، والتطور الحاصل في اندونيسيا على مستوى العلم العمران، وغيرها من الدول الاسلامية.
مد جسور التواصل والحوار بين الجميع اليوم أصبح أكثر من ضرورة، واعتماد خطاب أكثر عقلانية، بهدف مواجهة المخططات الغربية التي تواصل تدمير المنطقة وتفتيتها، فهذه أصبحت أهم وربما آخر فرص النجاح من أجل الحفاظ على مجتمعاتنا، وحماية مستقبلنا وسط هذه التحولات المخيفة في المنطقة والعالم ... وهي حقاً مخيفة.
