كان لزاماً على سوريا وهي الشريك الحقيقي بهزيمة هذا المشروع أن تطرح المشروع المشرقي بديلاً من «مشروع الشرق الأوسط الكبير». فطرح الرئيس الأسد نظرية «تشبيك البحار الخمسة» التي لم تلق ما تستحق من دراسة
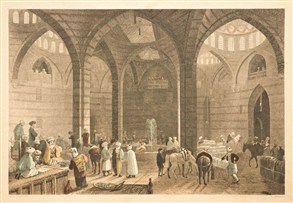 رسّخ مسار الأحداث في سوريا منذ أكثر من سنتين حقيقة مركزية سوريا في هذا الفضاء الجيوسياسي، الذي يتجاوز حدودها الحالية _ بلاد الشام أو سوريا الطبيعية _ إلى كل المشرق كمفهوم يفرض نفسه على المشهد الإقليمي والدولي بقوة الواقع التاريخي.
رسّخ مسار الأحداث في سوريا منذ أكثر من سنتين حقيقة مركزية سوريا في هذا الفضاء الجيوسياسي، الذي يتجاوز حدودها الحالية _ بلاد الشام أو سوريا الطبيعية _ إلى كل المشرق كمفهوم يفرض نفسه على المشهد الإقليمي والدولي بقوة الواقع التاريخي.
وقوامه الترابط البنيوي بين مكوناته ضمن نسق عام من التداخلات والتفاعلات بين كياناته، ينتقل معه الحديث عن المصير المشترك من مستوى المخيال الرومانسي للخطاب القومي، إلى الواقع الذي يتجسد في تأثير الحدث السوري على كل كيانات المشرق بطريقة تتجلى معه عبثية ولاموضوعية نظريات «النأي بالنفس» وسط هذه المشهدية الدرامية.
عبدالله بن عمارة / جريدة الأخبار
مركزية سوريا في المشرق فرضتها عوامل الجغرافيا والتاريخ المرتبطة أساساً بموقع سوريا الريادي، في الخريطة الجيوستراتيجية كما الحضارية والثقافية للمشرق والعالم كمحور للديانات السماوية الكبرى، التي تلون صورة المشهد العالمي الدينية، كمهد للديانة المسيحية ومركز لانبعاث الإسلام وقطب للإشعاع الحضاري، تماماً كما فرضها الدور الجوهري للنخبة السورية في التأسيس للبنية الفكرية وللإطار الابستيمي للمشروع النهضوي العربي. وفي القلب منه فكرة القومية العربية كأساس جامع للعرب ككتلة بشرية طامحة للتشكل في إطار دولة _ أمة ناهضة ومتحررة من السيطرة الاستعمارية.
هذه المركزية المتكئة على مقومات الجغرافيا والتاريخ والثقافة خلقت قابلية للانتظام ضمن هوية سورية طامحة إلى التشكل في إطار كيان مستقل حديث واع بكينونته، اصطدمت بواقع التحدي الخارجي الذي حال دون تشكل معالم الدولة _ الأمة في حدود سوريا الطبيعية، سواء كان هذا الخارج من داخل الفضاء المشرقي كتركيا _ في قمة صعود المد الطوراني _ أو من خلال الاستعمار الغربي الذي أقحم سوريا كمركز للمشرق في ميدان الصراع الدولي الذي دفعت من خلاله أثماناً باهظة من وحدتها الترابية (استقلال لبنان، تأسيس الأردن، اقتطاع لواء الاسكندرون، احتلال فلسطين) على مذبح اتفاقيات وصفقات الكبار سايكس _ بيكو 1916، بطرسبرغ 1916، فرساي 1919 ويالطا 1945.
حملت الدولة السورية الحالية ككيان وليد لهذا التقسيم الاستعماري عبء تحدي الغرب ومشاريعه الإمبريالية في المشرق ومواجهة الكيان الصهيوني من جهة، وتحدي النهضة والحفاظ على كيانية الدولة وسط مشهد جيوستراتيجي إقليمي ودولي مضطرب ومحكوم بالصراع من جهة أخرى. فرضت هذه التحديات على سوريا تبني المقاومة كضرورة وجودية للحفاظ على كينونتها، حيث وصلت لعبة الأمم في مراحل من تاريخها إلى تغيير سدة الحكم بانقلابات عسكرية نتيجة لحسابات مصلحية دولية نفطية أو استراتيجية (انقلاب حسني الزعيم نموذجاً).
لم تخرج سوريا من دائرة لعبة الأمم هذه، التي تلعب بقرارها السياسي الحاكم أو تجعل منها ميداناً للصراعات الإقليمية بين أسر أقحمها الغرب الاستعماري بطريقة أو بأخرى في المشهد المشرقي، تمثّل في الصراع بين آل سعود والهاشميين في فترة ما بين الحربين العالميتين أو للتجاذب بين المد الناصري والقوى الرجعية المناكفة له، في إطار مصغر للحرب الباردة بين القطبين العالميين في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، إلا بعد وصول الرئيس حافظ الأسد إلى الحكم الذي خلق استقراراً سياسياً ساعد في تحويل الكيان السوري «القلق» إلى دولة بمؤسسات حديثة ذات دور إقليمي وازن.
واستطاع أن يحول «الهوية السورية القلقة» إلى قوة دفع شكلت دينامية فعالة لإدارة الدولة السورية، وفق أيديولوجية قومية عربية جامعة طعمها بنكهة تستمد حركيتها من البيئة السورية الطبيعية ذات الامتداد المشرقي الواسع والمستندة إلى الإرث الحضاري القديم لسوريا _ السريانية والآرامية والكنعانية... بما أسس لبنية متكاملة لأيديولوجية موحدة جامعة تلبي ضرورة الحفاظ على وحدة الكيان السوري الحالي من التشظي والانقسام من جهة، وترسخ البعد السوري الطبيعي بل والمشرقي من جهة أخرى.
 أصل الرئيس حافظ الأسد لعقل استراتيجي يستبطن روحاً سورية طبيعية ومشرقية وضعت الدولة السورية في موقع صانعة القرار المستقل الضامن لمصالح مجالها الحيوي، الذي لم يكن سوى مجال سوريا الطبيعية _ بلاد الشام _ وامتداداته المشرقية. ولا يمكن هنا أن نرى قرار التدخل السوري في الأردن سنة 1970 (على محدوديته) أثناء أحداث «أيلول الأسود» إلا ضمن هذا الإطار، كما أنّه لا يمكن أن نفهم أبعاد قرار خطير مثل التدخل السوري في لبنان عام 1976 إلا في سياق قرار استراتيجي مرتبط برؤية مشرقية فذة تتعلق بمصلحة القضية الفلسطينية بمنع مقاومتها من فقدان البوصلة تحت أي ظرف، وبالحفاظ على بنية التكوين الفسيفسائي للنسيج الاجتماعي والديني للمشرق، وفي صلبه المكون المسيحي _ اللبناني، الذي يعتبر جزءاً أصيلاً من المسيحية المشرقية التي قلبها سوريا الذي تهدد آنذاك بالسحق والإبادة، بمغامرات تحركت بشعارات جنونية من قبيل «طريق فلسطين تمر من جونية». احتاج البعض من القوى اليسارية اللبنانية والفلسطينية إلى سنين، حتى يفهموا أبعاد القرار السوري آنذاك وصوابيته، بينما واصل البعض التأسيس للعداء لسوريا بحجج محاربتها لليسار أو «مصادرة القرار الفلسطيني» لينتهي المطاف ببعض هذا اليسار إلى خندق سياسي معادٍ للمقاومة ومرتبط بالرجعية العربية الخليجية، وبرواد استقلالية «القرار الفلسطيني المستقل» إلى غياهب تنازلات أوسلو.
أصل الرئيس حافظ الأسد لعقل استراتيجي يستبطن روحاً سورية طبيعية ومشرقية وضعت الدولة السورية في موقع صانعة القرار المستقل الضامن لمصالح مجالها الحيوي، الذي لم يكن سوى مجال سوريا الطبيعية _ بلاد الشام _ وامتداداته المشرقية. ولا يمكن هنا أن نرى قرار التدخل السوري في الأردن سنة 1970 (على محدوديته) أثناء أحداث «أيلول الأسود» إلا ضمن هذا الإطار، كما أنّه لا يمكن أن نفهم أبعاد قرار خطير مثل التدخل السوري في لبنان عام 1976 إلا في سياق قرار استراتيجي مرتبط برؤية مشرقية فذة تتعلق بمصلحة القضية الفلسطينية بمنع مقاومتها من فقدان البوصلة تحت أي ظرف، وبالحفاظ على بنية التكوين الفسيفسائي للنسيج الاجتماعي والديني للمشرق، وفي صلبه المكون المسيحي _ اللبناني، الذي يعتبر جزءاً أصيلاً من المسيحية المشرقية التي قلبها سوريا الذي تهدد آنذاك بالسحق والإبادة، بمغامرات تحركت بشعارات جنونية من قبيل «طريق فلسطين تمر من جونية». احتاج البعض من القوى اليسارية اللبنانية والفلسطينية إلى سنين، حتى يفهموا أبعاد القرار السوري آنذاك وصوابيته، بينما واصل البعض التأسيس للعداء لسوريا بحجج محاربتها لليسار أو «مصادرة القرار الفلسطيني» لينتهي المطاف ببعض هذا اليسار إلى خندق سياسي معادٍ للمقاومة ومرتبط بالرجعية العربية الخليجية، وبرواد استقلالية «القرار الفلسطيني المستقل» إلى غياهب تنازلات أوسلو.
انطلقت توجهات الرئيس حافظ الأسد المشرقية من حقيقة تموضع سوريا الحتمي في النسق الاستقلالي ذي النزعة المعادية بالضرورة للمشروع الغربي الاستعماري، وكيانه الوظيفي ذي المشروع العنصري التوسعي والمهدد لكل المشرق، والذي فرض وجوده تحدياً شكّل عائقاً أساسياً أمام طموح الدولة السورية الحالية في الوحدة والنهضة، وفي التعبير عن ذاتها ووعيها بهويتها المجروحة بلحظة اغتصاب سوريا الجنوبية _ فلسطين _. وهذا ما تجسّد في الانخراط الاستثنائي المبكر للسوريين في الصراع مع الصهيونية منذ 1936 (عز الدين القسام نموذجاً) الذي رسخ الترابط العضوي مع فلسطين كقطعة لا تتجزأ من البنية العضوية السورية اعترفت به القوى الفلسطينية حتى بعد تشكل الحركة الوطنية الفلسطينية.
واصلت سوريا بعد وصول بشار الأسد إلى الحكم استراتيجيتها القائمة على أساس دعم المقاومتين اللبنانية والفلسطينية ضد الاحتلال، ولكنها واجهت استحقاقاً أخطر متعلقاً باصطدامها المباشر بالمشروع الأميركي الإمبراطوري في أقصى حالات تمدده في عهد المحافظين الجدد من خلال قوته العسكرية، لا من خلال أداته الوظيفية كما حدث في حرب 2006 من خلال دعمها المقاومة العراقية منذ احتلال العراق سنة 2003.
 كان لزاماً على سوريا وهي الشريك الحقيقي في هزيمة هذا المشروع أن تطرح المشروع المشرقي بديلاً من «مشروع الشرق الأوسط الكبير». فطرح الرئيس الأسد نظرية «تشبيك البحار الخمسة» التي لم تلق بعد ما تستحق من دراسة علمية وأكاديمية تستوفيها من جميع جوانبها الاقتصادية كتجمع لاقتصادات نامية ولكتل بشرية وازنة من أكثر من 200 مليون نسمة، وثقافية بما تمثله من انتظام حضاري مشترك في نسق متكامل لحضارات قديمة ولإثنيات وقوميات وأديان مختلفة مصيرها التشبيك بين مصالحها الاقتصادية بدل تحويل فسيفسائها الدينية والإثنية إلى مصدر للاحتراب والاشتباك. كان مجرد طرح هذا المشروع من سوريا كمركز لهذا المشرق ومحور استقلالية القرار ومجابهة الاستعمار فيه، قمة التحدي للمشاريع الغربية ليس فقط في إطاره الميداني العسكري على جبهات المقاومة، وإنما في القدرة على ملء الفراغ الاستراتيجي بمشروع المشرق الجديد.
كان لزاماً على سوريا وهي الشريك الحقيقي في هزيمة هذا المشروع أن تطرح المشروع المشرقي بديلاً من «مشروع الشرق الأوسط الكبير». فطرح الرئيس الأسد نظرية «تشبيك البحار الخمسة» التي لم تلق بعد ما تستحق من دراسة علمية وأكاديمية تستوفيها من جميع جوانبها الاقتصادية كتجمع لاقتصادات نامية ولكتل بشرية وازنة من أكثر من 200 مليون نسمة، وثقافية بما تمثله من انتظام حضاري مشترك في نسق متكامل لحضارات قديمة ولإثنيات وقوميات وأديان مختلفة مصيرها التشبيك بين مصالحها الاقتصادية بدل تحويل فسيفسائها الدينية والإثنية إلى مصدر للاحتراب والاشتباك. كان مجرد طرح هذا المشروع من سوريا كمركز لهذا المشرق ومحور استقلالية القرار ومجابهة الاستعمار فيه، قمة التحدي للمشاريع الغربية ليس فقط في إطاره الميداني العسكري على جبهات المقاومة، وإنما في القدرة على ملء الفراغ الاستراتيجي بمشروع المشرق الجديد.
لقد بيّنت مجريات الأحداث منذ بداية الحرب على سوريا مدى ذوبان الحواجز الجغرافية المصطنعة بين كيانات هذا المشرق أمام حجم التداخلات والتفاعلات بين كل مكوناته، أهمية وصوابية الطرح المشرقي الشامل للدولة السورية الذي بدأ مع الرئيس حافظ الأسد. كما بيّن الحاجة الملحة التي يفرضها الواقع التاريخي على بعض التيارات القومية العربية التي لا تزال تعيش تناقضاً بنيوياً يلامس حدّ الانفصام، وأمام دور إيران في مواجهة الحرب على سوريا، فضلاً عن التحالف العضوي معها في مواجهة المشاريع الإمبريالية في المشرق، أن تعيد قراءة المشهد الإيراني بعيداً عن رواسب تراث «قادسية القرن العشرين» التي خلقت جذر انعدام الثقة مع جار يجعل من مركزية سوريا في المشرق محوراً لسياسته، وشريكاً مشرقياً عضوياً في نموذج الاستقلال ومواجهة مشاريع الهيمنة، آن لهم الاعتراف أمام لحظة مكاشفة ذاتية شجاعة بأنه ما كان لأحد أن يفكر في إطار تنسيقي.
ناهيك عن الوحدة بين سوريا والعراق في ظلّ «عراق العداء لسوريا وإيران»، وأن هذا العراق الذي يتعرض لهجمة وهابية رجعية إجرامية يحتاج إلى مشروع وطني جامع لكل مكوناته المذهبية والإثنية، والذي لن يتكرس إلا من خلال القطيعة مع تراث «العداء الهستيري لسوريا وإيران»، ورفض كل نزوع طائفي انعزالي يتعاطى مع مكوناته على أساس مذاهبهم وإثنياتهم.
دولة المقاومة في سوريا كقطب ترتبط به جميع صراعات هذا المشرق تخوض اليوم حرباً من أجل مشرق جديد مستقل عن الهيمنة الاستعمارية، متعدد ورافض لكل المشاريع الإقصائية التكفيرية والصهيونية.
* كاتب جزائري
