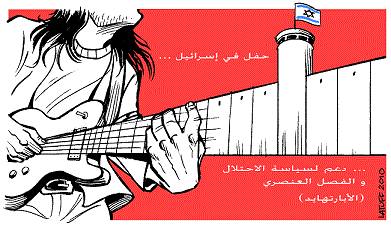«سيستمر الاحتلال (...)، وسيتم تطهير غور الأردن من العرب، وكذلك خنق القدس العربية بالأحياء اليهودية. وطبعاً، فإن أي عمل من أعمال السرقة والحماقة التي تخدم التوسع اليهودي، سيكون موضع ترحيب من قبل محكمة العدل العليا.
يثير البؤس الناتج عن الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حالة قلق حقيقية، على الأقل، لدى بعض الإسرائيليين. أحد أبرز من كتب بصراحة في هذا السياق، هو جدعون ليفي في «هآرتس»، يقول: «يجب أن تُدان إسرائيل وتُعاقب، على خلق حياة لا تحتمل في ظل الاحتلال (...)، وعلى مواصلتها استغلال شعب بأكمله، ليلاً نهاراً».
نعوم تشومسكي/ جريدة السفير
ترجمة: ملاك حمود
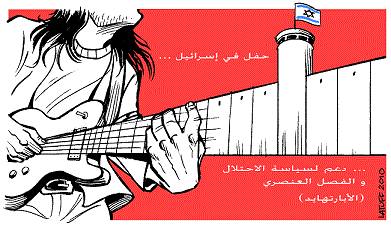 هو بالطبع على حق، وعلينا هُنا إضافة ما هو أكثر من ذلك: «يجب أن تُدان الولايات المتحدة وتُعاقب على توفير الدعم العسكري والاقتصادي والديبلوماسي، وحتى الأيديولوجي للجرائم الإسرائيلية. وطالما أن واشنطن لا تزال تواصل دعمها للكيان، فلن يكون هناك ما يدعو إسرائيل إلى أن تلين في سياساتها الوحشية».
هو بالطبع على حق، وعلينا هُنا إضافة ما هو أكثر من ذلك: «يجب أن تُدان الولايات المتحدة وتُعاقب على توفير الدعم العسكري والاقتصادي والديبلوماسي، وحتى الأيديولوجي للجرائم الإسرائيلية. وطالما أن واشنطن لا تزال تواصل دعمها للكيان، فلن يكون هناك ما يدعو إسرائيل إلى أن تلين في سياساتها الوحشية».
وفي مراجعة للمد القومي الرّجعي في بلاده، يكتب الباحث الإسرائيلي البارز زئيف ستيرنهيل: «سيستمر الاحتلال (...)، وسيتم تطهير غور الأردن من العرب، وكذلك خنق القدس العربية بالأحياء اليهودية. وطبعاً، فإن أي عمل من أعمال السرقة والحماقة التي تخدم التوسع اليهودي، سيكون موضع ترحيب من قبل محكمة العدل العليا. (...) هذا لن يتوقف، إلا حين يقرر العالم الغربي وضع إسرائيل أمام خيارين: التوقف عن التوسع الاستيطاني، أو النبذ».
السؤال الحاسم هو ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتوقّف عن تقويض الإجماع الدولي، الذي بدوره، يفضّل تسوية في إطار حلّ الدولتين على طول الحدود المعترف بها دولياً، مع ضمانات لـ«سيادة وسلامة واستقلال جميع الدول في المنطقة، وحقها في العيش بسلام داخل حدود آمنة ومعترف بها».
لم تكن تلك المرة الأولى التي تعطّل فيها واشنطن تسوية ديبلوماسية سلمية. جائرة التعطيل حينذاك، تعود إلى وزير الخارجية هنري كيسنجر الذي دعم قرار إسرائيل في رفضها التسوية التي قدمها الرئيس المصري أنور السادات العام 1971. ومنذ ذلك الحين، اختارت إسرائيل التوسع على حساب الأمن، بدعم من الولايات المتحدة. ويصير في بعض الأحيان موقف واشنطن كوميدياً، كما حصل في شباط 2011، عندما اعترضت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما على قرار الأمم المتحدة، الذي أيّد سياسة الولايات المتحدة الرسمية: معارضة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، الذي يستمر (أيضاً بدعم أميركي)، بالرغم من بعض همسات الاعتراض.
تلك ليست مسألة توسع استيطاني أو برامج بُنى تحتية، (بما في ذلك جدار الفصل العنصري). (...) فكل ذلك غير شرعي، بحسب ما هو محدّد في مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، ومعترف فيه من قبل العالم، في ما عدا إسرائيل والولايات المتحدة».
في العام 1997 بدأت مجموعة السلام الإسرائيلية «غوش شالوم» بمعاقبة إسرائيل على جرائمها الفظيعة: مقاطعة منتجات المستوطنات. وتوسعت تلك المبادرة إلى حدّ كبير منذ ذلك الحين. كان آخرها مصادقة الكنيسة «المشيخيّة» الأميركية على سحب استثماراتها من ثلاث شركات أميركية كبرى تعمل في المستوطنات. والنجاح بعيد المدى الذي حققته حركة المقاطعة يتمثّل في توجيه الاتحاد الأوروبي سياسة تحظر التمويل والتعاون والجوائر البحثية أو أي علاقة مماثلة مع أيّ كيان إسرائيلي له علاقات مباشرة أو غير مباشرة بالأراضي المحتلة، حيث كل المستوطنات غير شرعية، بحسب ما ينصّ أيضاً، إعلان الاتحاد الأوروبي.
خلال العقد الماضي كان هناك العديد من مبادرات المقاطعة وسحب الاستثمارات. إلا أن المبادرات تلك، نادراً ما كانت تصل إلى المسألة الحاسمة التي تتمثّل بدعم الولايات المتحدة الجرائم الإسرائيلية. في الوقت ذاته، تشكّلت حملة «المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات» BDS، محاولة استنساخ التجربة الجنوب أفريقية. وللدقة أكثر، فإن اسم الحملة يجب أن يُختصر لـ BD أي «المقاطعة وسحب الاستثمارات» فقط، لأن فرض العقوبات ليس مطروحاً، وتلك واحدة من أبرز الاختلافات مع النموذج الجنوب الأفريقي.
تطالب الحملة بامتثال إسرائيل الكامل للقانون الدولي عبر: «إنهاء احتلالها لأراضي العام 1967، وتفكيك جدار الفصل العنصري. المساواة والاعتراف بالحقوق الأساسية للمواطنين الفلسطينيين. احترام وحماية وتعزيز حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم، كما هو منصوص عليه في قرار الأمم المتحدة رقم 194».
تلقى تلك الدعوة اهتماماً كبيراً، وذلك بجدارة طبعاً. ولكن، إذا كنا فعلاً قلقين على مصير الضحايا، فعلى حركة «المقاطعة وسحب الاستثمارات» أن تفكّر بعناية وتقيّم العواقب المحتملة لمبادرتها. ويبقى السعي إلى تحقيق مطلب إنهاء احتلال أراضي العام 1967 منطقياً جداً: فذلك يفهمه الجمهورُ المستهدف في الغرب.
ولكن مطلب حق عودة اللاجئين له حسابات أخرى. بينما لا يوجد هناك إجماع دولي على إنهاء احتلال أراضي العام 1967، فلن يكون هناك، عملياً، دعم يذكر لمطلب حق العودة، إلا من خلال الحملة نفسها.
أما قضية الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني فتعدّ أكثر غموضاً. فهناك «حظر ضد التمييز» في القانون الدولي، كما تلاحظ منظمة «هيومن رايتس ووتش». ولكنّ السعي خلف تحقيق الاعتراف بحقوق الفلسطينيين ربما يفتح الباب أمام رد فعل على مبدأ «بيت من زجاج»: مثلاً إذا قاطعنا جامعة تل أبيب لأن إسرائيل تمارس انتهاكات إنسانية، فلماذا إذاً لا نقاطع جامعة هارفارد بسبب الانتهاكات الأكبر التي تمارسها الولايات المتحدة؟ وكما هو متوقع، فإن كل المبادرات التي تركّز على الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني فشلت، وستستمر في الفشل ما لم تبذل جهود تعليمية لتأمين الأرضية الصلبة لفهم الجمهور، كما حدث في الحالة الجنوب أفريقية.
تلك المبادرات الفاشلة تضرّ بالضحايا على نحو مضاعف، عن طريق تحويل الانتباه عن محنتهم الأساسية إلى قضايا أخرى لا صلة لها بالقضية المركزية، وبإضاعة الفرصة الحالية أمام القيام بشيء ذي مغزى.
أخيراً بدأت معارضة داخلية في الولايات المتحدة ضدّ الجرائم الإسرائيلية، إلا أن هذا لا يعني أنه يمكن مقارنتها بالتجربة الجنوب أفريقية، لأنه لم يتم حتى الآن إنجاز «التعليم اللازم». المتحدثون باسم حملة BDS ربما يصدقون أنهم بلغوا اللحظة «الجنوب أفريقية»، وذلك هو أبعد ما يكون عن الدقة. وإذا أرادت الحملة أن تصير تكتيكاتها فاعلة، فعليها أن تستند إلى تقييم واقعي للظروف المحيطة.
في الضفة الغربية ستواصل إسرائيل أخذ كل ما تجده قيماً ـ (أرض، مياه، موارد) ـ مُشتتة كتلة السكان الفلسطينيين المحدودة، في وقت تدمج فيه مكتسباتها ضمن إسرائيل الكبرى. يتضمن ذلك «القدس» الموسعة بشكل كبير، والتي ألحقتها إسرائيل بأراضيها في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي؛ كل شيء من الجهة الإسرائيلية لجدار الفصل العنصري؛ ممرات إلى الشرق تخلق كانتونات فلسطينية غير قابلة للحياة؛ غور الأردن، حيث يجري طرد الفلسطينيين بشكل مُمنهج، فيما تقام المستوطنات اليهودية، بالإضافة إلى ذلك، مشاريع بُنى تحتية ضخمة تربط بين مجموع هذه المكتسبات لمصلحة إسرائيل.
لا يقود ذلك المسار إلى جنوب أفريقيا، بل إلى زيادة في نسبة اليهود في إسرائيل الكبرى التي يجري إنشاؤها. سيصبح ذلك البديل الواقعي لتسوية حل الدولتين، لأنه لا يوجد سبب يدفع إلى توقّع أن تقبل إسرائيل بسكان فلسطينيين لا ترغب فيهم.
وجرى مؤخراً التنديد بشدة بكلام وزير الخارجية الأميركي جون كيري عندما قال: إن «إسرائيل ستتحول إلى دولة فصل عنصري، تسيطر على أرض تسكنها غالبية فلسطينية مقموعة»، في حال لم تقبل بتسوية لا تشمل حل الدولتين. (...) ما دامت الولايات المتحدة تدعم السياسات الإسرائيلية التوسعية، لا يوجد سبب يدفع إلى ترقّب انكفائها.
في أي حال، لا توجد مقارنة واقعية مع نموذج جنوب أفريقيا. في العام 1958، أبلغ وزير الخارجية الجنوب أفريقي السفير الأميركي بأن تحوّل جنوب أفريقيا إلى دولة منبوذة لا يهم كثيراً. وقال «يمكن للأمم المتحدة أن تدين بشدة نظام جنوب أفريقيا». لكن، وبحسب ما نقل عنه السفير: «لعل ما يهم أكثر من مجموع الأصوات الأخرى، هو صوت الولايات المتحدة في ضوء مكانتها الريادية ضمن العالم الغربي».
 بالنسبة لجنوب أفريقيا، كانت الحسابات ناجحة إلى حدّ ما، ولوقت طويل. في العام 1970، انضمت الولايات المتحدة إلى بريطانيا، واضعة الفيتو الأول لها ضد قرار في مجلس الأمن الدولي لإدانة النظام العنصري في روديسيا الجنوبية، في خطوة أعيد اتخاذها في العام 1973. في نهاية الأمر، تحوّلت واشنطن إلى بطلة الأمم المتحدة في اتخاذ «الفيتوات» وبفارق واسع، في قرارات مرتبطة في المقام الأول بالدفاع عن الجرائم الإسرائيلية. ولكن، في ثمانينيات القرن الماضي، كانت الإستراتيجية الجنوب أفريقية قد بدأت تخسر من فعاليتها.
بالنسبة لجنوب أفريقيا، كانت الحسابات ناجحة إلى حدّ ما، ولوقت طويل. في العام 1970، انضمت الولايات المتحدة إلى بريطانيا، واضعة الفيتو الأول لها ضد قرار في مجلس الأمن الدولي لإدانة النظام العنصري في روديسيا الجنوبية، في خطوة أعيد اتخاذها في العام 1973. في نهاية الأمر، تحوّلت واشنطن إلى بطلة الأمم المتحدة في اتخاذ «الفيتوات» وبفارق واسع، في قرارات مرتبطة في المقام الأول بالدفاع عن الجرائم الإسرائيلية. ولكن، في ثمانينيات القرن الماضي، كانت الإستراتيجية الجنوب أفريقية قد بدأت تخسر من فعاليتها.
ففي العام 1987، حتى إسرائيل ـ ولعلها الدولة الوحيدة المنتهكة لحظر التسليح المفروض ضد جنوب أفريقيا حينذاك ـ وافقت على «تقليص علاقاتها (مع جنوب أفريقيا؟) تجنباً لتعريض علاقاتها مع الكونغرس الأميركي للخطر»، كما ذكر المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية. تأتّى ذلك القلق من واقع أنّ الكونغرس قد يُعاقب إسرائيل لانتهاكها قوانين أميركية جديدة. وحينها، أكد المسؤولون الإسرائيليون لأصدقائهم الجنوب أفريقيين أنّ العقوبات الجديدة ستكون مجرد «واجهة». وبعد أعوام قليلة، انضم آخر الداعمين في واشنطن إلى سياق الإجماع العالمي، ليسقط نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.
في جنوب أفريقيا، جرى التوصل إلى تسوية ترضي النخب في البلاد والمصالح التجارية للولايات المتحدة: انتهى التمييز العنصري، لكن النظام الاجتماعي - الاقتصادي بقي قائماً. في الواقع، سيكون هناك بعض الوجوه السوداء في سيارات الليموزين، إلا أنّ الامتيازات والمكتسبات لن تتأثرا كثيراً. أما في فلسطين، فلا يوجد تسوية مماثلة متوقّعة.
عامل حاسم آخر في جنوب أفريقيا كان كوبا (...) التي أدّت دوراً قيادياً في إنهاء التمييز العنصري وفي تحرير أفريقيا السوداء عموماً. زار نيلسون مانديلا هافانا بُعيد خروجه من السجن، وقال حينها: «جئنا إلى هنا شاعرين بالدين الكبير إلى شعب كوبا (...)».